- التفاصيل

في زمن التحوّلات الكبرى، ليست الهيمنة العسكرية أخطر ما يُكبِّل الأمم، بل الاستسلام العقلي والنفسي الذي يُقنع الشعوب بأنها ضعيفة، ويُشعرها بأن التغيير رهين رضا العدو أو موافقة الداعم، فيُخدّر الطاقات ويشلّ الإرادات، فيُمكّن للاستضعاف بدل التمهيد للتمكين.
وهذا تحديداً ما يُراد ترسيخه اليوم في بلاد الشام، بعد أن تكسّرت قوى الطغيان وانهارت أركان النظام، وتقدّمت الثورة إلى قلب العاصمة، فإذا بالخطاب المسيطر يعود ليقول "نحن دولة فقيرة، نحتاج دعم الخارج، لسنا قادرين على إدارة أنفسنا...، نحن ضعفاء ولنكن واقعيين ولنقبل بالواقع"!
غير أن الأخطر من مجرد الشعور بالاستضعاف، هو أن يتحول ترويج هذا الشعور وتحويله إلى سياسة ممنهجة تُزرع في الوعي الجمعي لشلّ إرادة التغيير والنهوض.
فهذا النمط من الخطاب الذي نشاهده لم ينشأ من فراغ، بل يُراد له أن يُصبح قاعدة، تغذيه جهات داخلية وخارجية تخشى من وعي الأمة وتحررها وثقتها بقدرتها على التغيير. فكلما اقتربت الأمة من لحظة الإمساك بقرارها، وامتلكت أدوات النهوض، سارعوا لتذكيرها كذباً أنها "غير مؤهلة"، وأن "الواقعية" تقتضي التنازل، وأن "العالم لن يسمح الآن"، وكأنّه سيسمح لهم غداً أو كأنّهم يظنّون أنهم يخدعونه!
وهنا تتحول "المرحلة الانتقالية" إلى عقيدة سياسية جامدة، يتعطّل فيها المشروع، وتُجمد فيها الثروات، وتُكبل فيها القيادة بأوهام الحاجة والعجز، فتزرع الهوان الذي في نفسها في نفوس شعبها.
حين دخل رسول الله ﷺ المدينة لم يطلب الإذن من قريش، ولم ينتظر اعتراف الروم، بل أقام دولة، ووضع دستوراً، وربّى رجالاً، وخاطب الأمم... لأنه كان يحمل مشروعاً عالمياً مبدئياً منبثقاً من الوحي، فاستحق نصر الله.
أما اليوم، فمتى نُدرك أن مشكلتنا ليست ضعفاً حقيقياً إنما هي الوهم المصطنع؟
ومتى ندرك بأنَّ الحاضنة هي جوهر القوة؟
في سوريا، الحاضنة الثورية التي لم تُهزم، بل ما زالت قادرة على العطاء، هذه الحاضنة التي قدّمت أولادها وأموالها ودعمت الثورة في أحلك الظروف، ولكنها بعد سقوط النظام البائد تُعامَل باعتبارها مجرّد جمهور يُراد ضبطه لا تحشيده، يُستحضر حين الحاجة ويُقصى حين الخلاف، وتسعى الإدارة الجديدة للقضاء على روح الثورة والجهاد في نفوس الحاضنة.
متى ندرك أنَّ الدولة تُبنى بالحاضنة لا على حسابها، وبالمشروع لا بالتكتيك، وبقيادة صادقة مبدئية لا بحسابات المناصب والمرحلة؟!
إن من أهم ما يُقوّض النهوض الحقيقي هو أن يُختزل دور الناس في الصمت والانتظار، وأن يُختزل دور القيادة في التنسيق والتكتيك، فيغيب المشروع، ويتقدّم "الإجراء المؤقت" القائم على قاعدة "نحن ضعفاء" ليصير سياسة ثابتة.
إن النهوض لا ينتظر مؤتمراً دولياً، ولا يُصنَع القرار السياسي في قاعات الفنادق، ولا تستجدى الكرامة من عواصم الغرب. فالنهوض قرار ذاتي شجاع، والإقدام إيمان وثبات، والتمكين عطاء من الله لمن صدق وأخلص وثبت.
وهنا لا بد أن نقف لنُميّز بين من ضلّ الطريق تحت وطأة الواقع، ومن انتكس عن الثوابت تحت عباءة الواقعية، فالأول قابل للتصحيح بالحوار والمكاشفة، أما الثاني فمكانه على رصيف الإقصاء السياسي، لا في موقع القيادة.
فمن أراد تمكيناً حقيقياً، فليُعدّ عدته التي تتمثل بمشروع مبدئي، وقيادة واعية، وأمة مجندة، ونظرة إلى الله لا إلى واشنطن أو أنقرة أو الرياض، وثقة بالنفس لا انهزام داخلي وهوان.
فسوريا ليست ضعيفة ولا فقيرة، وهي غنية بثرواتها وطاقاتها المادية والبشرية: نفط، غاز، زراعة، موقع جغرافي نادر، وحاضنة معطاءة، ومع ذلك تُقدَّم على أنها منطقة منكوبة، وكأن الثورة ولّدت فقراً! بينما الفقر جاء من عقود النهب الممنهج على يد نظام أسد والذي ينبغي أن يُزال بزوال أسبابه لا بتلميعها أو الالتفاف حولها.
وهنا تعود على الدوام لتبرز أزمة القيادة الحالية التي تنظر للحاضنة الشعبية كحمل ثقيل لا كخزان قوة، وتحاول احتواء الناس لا الانفتاح عليهم، وكأن التمكين والعمل للتمكين مؤجل حتى إشعار دولي آخر لن يأتي!
إنّ الخطورة لا تكمن فقط في الخطاب الانهزامي، بل في تحوّله إلى مسلمات فكرية تُدرّس وتُكرر وتُشرعن في المؤتمرات والدراسات، حتى يُصبح النقد جريمة لمعارضته للواقع الفاسد وللواقعية التي تتخذ الرضا بفساد الواقع قاعدة لها، وحتى يصير البديل المبدئي طوباوية غير واقعية.
فما أحوجنا اليوم إلى خطاب صريح يحاكم الواقع ويقر بصعوباته ولكن لا يتكيف معه، يفتح أفق الأمة ولكن لا يسجنها في غرف التفاوض، خطاب يُنهي عقلية الانتظار والهوان، ويستبدل بها عقلية الإقدام والعزيمة، ويرفع سقف الثقة بالله لا بسفراء الغرب.
فالتمكين عندنا نحن المسلمين يأتي من الإيمان بالله لا بالأمم المتحدة. وما نعيشه اليوم هو لحظة نادرة في عمر الأمة، لا يجوز أن تُدار بعقلية المستضعف.
من امتلك الأرض، وحرّر العقول، وفضح المشروع الدولي، لا يجوز له أن يعود خطوة بل خطوات للوراء، لأنه بذلك يُفرّط بثمرة الجهاد، ويُعيد إنتاج النظام البائد بشعارات جديدة.
فالواجب ألا ننتظر اعترافاً دولياً أو معونة خارجية، بل نستنبط مشروعنا المنبثق من عقيدتنا، ونعيد اكتشاف ثرواتنا وطاقاتنا. ولا ينبغي أن نبقى في آخر الركب ننتظر قيادة توافقية ونصفق لدروشتها، بل نُفرز قيادة صادقة تحمل مشروعاً مبدئياً دون مساومة.
إن الثورة باعتبارها فكرة راسخة في قلوب الناس لا تزال ذاخرة بالطاقات، والحاضنة لا تزال تنبض بالإيمان، وما على أصحاب العزم إلا أن يشمّروا ويقودوها بصدق وثبات، فاللحظة لحظة نهوض، لا لحظة مساومة، والقرار يجب أن يُصنع هنا، على الأرض، لا هناك في غرف المساومات على يد المندوب السامي باراك!
- التفاصيل
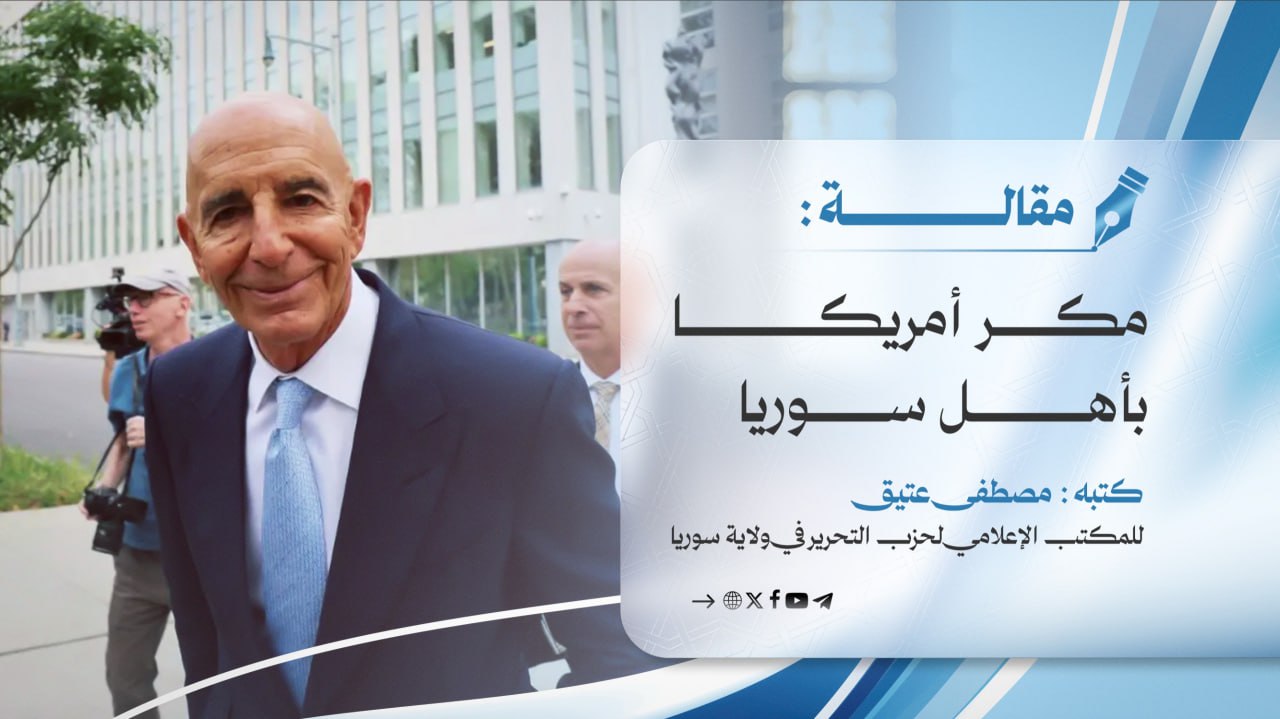
الاهتمام الأمريكي بسوريا لا يخفى على أحد، ونرى مؤخرا سيلاً من المديح والمحبة والاهتمام الزائد وبشكل ملفت للنظر، حتى أن المبعوث الأمريكي، توم باراك، لا يغادر المنطقة، فمن المؤكد أن هذه المحبة المزعومة ليست مجانية ولها مقابل أكبر وأغلى مما يريده الشعب السوري. فأمريكا عدو للإسلام والمسلمين وهي من تدعم يهود في قتل أهلنا في غزة وهي من تساند أنظمة العالم الإسلامي لقهر شعوبهم ونهب خيراتهم، وهي من كانت على مدى سنوات الثورة داعمة لنظام الأسد البائد، وهي وراء كل مصيبة في العالم، وهي من يُوجِد ويُدير بؤر الصراع في العالم ولا تحلها إلا بما يخدم مصلحتها.
هذا المكر الأمريكي بأهل سوريا جعل الحكومة الانتقالية تتراخى أمام المجتمع الدولي وتحرص على رضاه، وبات مفعول الخداع السياسي كبيرا في كافة مفاصل الدولة. فعلى ما يبدو أن الإدارة الحالية تصدق كل التصريحات الآتية من أمريكا ودول الغرب الكافر الخاصة بالدولة والقيادة، وحتى أنك ترى أثرها في العلاقات الخارجية وخاصة دول الجوار . مع العلم أن القاصي والداني يعرف أن أمريكا والغرب الكافر يعاديان الإسلام والمسلمين جميعاً
يقول تعالى :( وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ).
فعلى حكومة دمشق أن تحذر ما يحاك وراء الكواليس وأن يحذروا من السم المدسوس بالعسل وأن لا يركنوا ويصدقوا كل ما يسمعونه ويرونه من أمريكا، وعليهم أن يفكروا خارج الصندوق الذي وضعتهم فيه، وأن لا يسارعوا في مرضاتهم والسمع منهم بحجة الحفاظ على سلامة البلاد.
يقول تعالى: (فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ).
وعلى حكومة دمشق أن تدرك أن أمريكا لا تتقيد بالأعراف الدولية والقيم السياسية، فلا منطق ولا صدق ولا مصداقية في علاقاتها مع دول العالم بل يوجد دهاء ومكر واصطياد في الماء العكر والصافي .
وعلى حكومة دمشق التفكير باستراتيجية قوة الإسلام ومعية الله، فهذا هو البعد الاستراتيجي الحقيقي مع الحفاظ على عقلية الحرب والمعارك والثورة، لأن المعركة لم تنته ولم تضع الحرب أوزارها كما يزعم ساسة دمشق، والحرب لم تنته داخلياً ولا اقليمياً، والواجب عليهم أن يحيطوا أنفسهم بدهاة السياسة والمفكرين الاستراتيجين للحفاظ على الأمن والأمان داخلياً وخارجياً .
وليعلم من هم في الحكم في سوريا أن العلاقات الدولية قائمة على غير الإسلام بل قائمة على أساس السيطرة الرأسمالية على مقدرات الشعوب وكل ما هو في صالح الدول الغربية وأبرز ما يسعون إليه هو الحيلولة دون وجود كيان للمسلمين يتمثل في دولة تقيم حكم الإسلام ونحن أمام خيارين لا ثالث لهما إما أن نختار رضى الغرب ونسير في ركابه ووفق توجيهاته فنصبح أذلاء تابعين له ننفذ أوامر ونطبق رأسماليته العفنة فنشقى في الدنيا و الآخرة، وإما أن نطلب رضى الله ومعيته باتباع شرعه وإقامة الحكم بما أنزل وفي ذلك عزنا وفوزنا في الدنيا و الآخرة.
كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
مصطفى عتيق
- التفاصيل

بحضور حشد كبير من رجال الأعمال آتين من السعودية إلى دمشق بتوجيه من ابن سلمان ولي العهد السعودي عقد منتدى الاستثمار السعودي السوري، بتاريخ ٢٤/٧/٢٠٢٥ وتوقيع ٤٧ اتفاقية بقيمة 4-6 مليار دولار، وصرح عدد من المسؤولين السعوديين بأن هذه الخطوة ستكون نقطة انطلاقة لتدفق الاستثمارات إلى البلاد بهدف النهوض باقتصادها والقيام بتحالفات استثمارية دولية لجذب الاستثمار إلى سوريا.
وهذا المنتدى عقد في دمشق، وعلى مقربة منه أحداث السويداء الدموية على أوجها والمسلمون يهجرون منها ويذبحون ورجال الأمن والجيش يُقَتَّلون ويمثل بجثثهم، وكأن الدولة تقول إن المستثمرين والأموال أولى من دماء المسلمين، مع العلم أن المنتدى عقد بدعم من مملكة آل سعود التي خذلت غزة وهي تدمَّر من كيان يهود بل مررت ليهود المؤن والعدة والعتاد من موانئ الإمارات والقواعد الأمريكية ولم تبالِ بدماء المسلمين. والغاية من هذا الاهتمام السعودي هو احتواء القرار السياسي والاقتصادي لحكومة دمشق ليسهّل الإملاءات التي تخدم مصالح أمريكا.
وقد أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن القطاع الخاص السعودي هو الشريك الأول لسوريا في هذه المرحلة وبتوجيه من ولي العهد يشترك في المنتدى ٢٠ جهة حكومية إلى جانب أكثر من ١٠٠ شركة رائدة في القطاع الخاص وأكد أن هذه الشركات بصدد الدخول إلى السوق السورية في مجالات حيوية تشمل الطاقة والصناعة والبنية التحتية والعقارات والخدمات المالية والصحة والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والمقاولات والتعليم وغيرها، وسيتم إنشاء معامل إسمنت جديدة. وقال الفالح إن الخطوات الجريئة والإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية لتحسين مناخ الاستثمار وفي مقدمتها تعديل قانون الاستثمار بتاريخ ٢٤ حزيران عام ٢٠٢٥ والذي منح المستثمرين مزيداً من الضمانات والحوافز وتسهيل إجراءات الاستثمار ما يهيئ بيئة أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.
لم تتبنَّ الإدارة السورية للمرحلة الانتقالية أي مشروع سياسي ترعى فيه شؤون الناس منبثق عن العقيدة الإسلامية، وهي في الأصل لا تملك أي مشروع سياسي لقيادة الدولة والمجتمع، ولكن منذ البداية بعد إسقاط بشار المجرم في ٨/١٢/٢٠٢٤ صرحت بأنها ستتبنى النظام الاقتصادي الحر الرأسمالي وسوف تسمح للاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة المجالات، سواء في الملكيات العامة أو المرافق العامة (الموانئ والمطارات والكهرباء وغيرها..). متغافلة عن خطورة الاستثمارات الأجنبية وأخطارها وخاصة عندما لا تكون رجل دولة ولا تملك رؤية للمستقبل وليس لديك مشروع متكامل لقيادة الدولة فإنك ستكون أداة لتنفيذ مشاريع الآخرين.
ومن المعلوم بالسياسة بالضرورة أن النظام العالمي القائم الآن هو نظام رأسمالي جشع تقوده مؤسسات رأسمالية ربوية همها نهب دول العالم.
وبالعودة إلى المنتدى الاقتصادي للمستثمرين، فهل تظن حكومة دمشق أن هؤلاء جاؤوا لبناء الاقتصاد السوري المنهار؟! بل لقد جاؤوا لنهب خيرات البلاد، فهؤلاء ليسوا جمعيات خيرية بل هم رأسماليون همهم تحصيل أكثر ما يمكن من الأرباح ولو على حساب الشعب السوري.
ونذكّر إدارة دمشق أن بناء الاقتصاد يكون بأيدي أهل البلاد وبرعاية الدولة وتحت إشرافها وليس بأيدٍ خارجية تحمل أجندات شتى. فعلى الدولة تحديد ما يمكن أن يستثمر فيه الأفراد والذي لا يتجاوز إلى الملكيات العامة التي تُستثمر برعاية الدولة ومباشرتها لها وتكون محافظة عليها للصالح العام.
ومن مصائب الاستثمار الخارجي فقدان الدولة لسيادتها على جزء من أراضيها الخاضعة للاستثمار وسهولة دخول العملاء والجواسيس إلى البلاد بحجة الاستثمار، وحدوث اختراقات لواقع الحياة الثقافية والاجتماعية في البلد. هذا عدا عن عملية النهب والسلب لخيرات البلاد إلى الخارج ودخول البلاد ضمن المؤسسات الرأسمالية في العلاقات والمعاملات والعقود الاقتصادية التي يغلب عليها طابع الربا والاحتكار.
ومن أبرز المخاطر التي تأتي من الاستثمار الخارجي عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي الناتج عن المستثمرين وإملاءاتهم وضغوطهم على الدولة وابتزازها وكثرة التغييرات في القوانين والتشريعات التي تكون في صالح المستثمرين وتخدم مشاريعهم، وعدم استقرار العملة بسبب التحويلات المالية الصادرة من البلد والخارجة التي تؤثر على السيولة النقدية في البلاد والوقوع في حالة التضخم. ومن مخاطر المستثمرين إدخال ثقافة المستثمرين في البلاد وحياتهم الاجتماعية المخالفة لأهل البلاد وظهور الفساد والرشوة والمحسوبيات والتلاعب في الأسواق والاحتكار.
أما النظرة الإسلامية في الاقتصاد، فإن مهمة الدولة تأمين الحاجات الأساسية للأفراد داخل الدولة أولاً مع السعي لتأمين الكماليات وبيان كيفية التملك والتصرف في الملك وبيان ما هي الملكيات العامة والمرافق العامة التي تكون ملكاً لعامة الناس برعاية الدولة كالثروة الباطنية والمرافق العامة كالموانئ والمطارات والطرق والكهرباء والمياه والشواطئ والأنهار والتعليم والصحة والأمن وما شابهها، وكذلك تبين للأفراد ما يحق لهم تملكه. فعلى الدولة أن تقوم بمراجعة للناحية الاقتصادية بما يرضي الله بالحفاظ على الأموال والأنفس، وأن تكون حريصة على أموال المسلمين من الهدر والسلب والنهب والخروج خارج البلاد بإيجاد المشاريع التي تبني الاقتصاد الحقيقي والقوي، وهذه هي المعالجات التي ترضي ربنا وتحقق استقرارنا وتضمن سيادتنا واستقلال قرارنا.
-------------
بقلم: الأستاذ مصطفى عتيق
- التفاصيل

إن الإسلام هو دين عملي جاء بأحكام تفصيلية لجميع شؤون الحياة ومعالجة جميع المشاكل التي تطرأ على حياة الإنسان، ولقد جاء بأمور جعلها ملازمة لبعضها فلا يغني أمر عن أمر آخر، منها "الإخلاص والوعي" و "الدعاء والعمل"، فهذان الصنفان لا يمكن لمسلم أن يختار واحدة ويترك الأخرى، أو يعمل بواحدة فقط، فهما أمران متلازمان لا ينفصلان عن بعضهما البعض. فالمسلم يجب أن يكون مخلصاً لله واعياً على أوامره ونواهيه سبحانه، منفذاً لها مبصراً لطريقه فاهماً لقضيته، يراقب عدوه ويكشف خططه ولا ينجر وراءه فيتيه عن طريقه وعمله الذي فرضه الله عليه.
وأيضا "الدعاء والعمل" هما أمران متلازمان وخاصة في موضوع نصرة إخواننا المستضعفين في غزة، فالدعاء فقط يقبل من المستضعفين والذين لا حول لهم ولا قوة ولا يستطيعون ضرباً في الأرض فيُقبل منهم، أما من أهل القوة والسلطان فلا يقبل دعاؤهم وحده، وإن اكتفوا بالدعاء فلينتظروا غضب الله ومقته.
إن صاحب القوة والسلطان لا يقبل منه في وقتنا الحالي إلا العمل على إسقاط الأنظمة المرتبطة بالغرب الكافر وكسر الحدود وتحريك الجيوش لنصرة أهلنا في غزة العزة وتحرير بيت المقدس من رجس يهود وإعطاء النصرة لمن هو أهل لها لإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، فهي التي سيعز بها المسلمون وسينجي الله بها المستضعفين في كل بقاع الأرض وهي التي ستنشر الإسلام بالدعوة والجهاد لجميع أصقاع الدنيا وما ذلك على الله بعزيز.
قال تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا﴾
كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية سوريا
إبراهيم معاز








